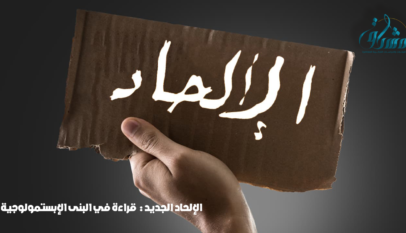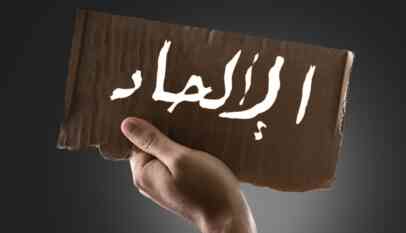مشروع قانون الأحوال الشخصيّة المدنيّ في نظر الشّرع المقدس: ملاحظاتٌ نقديّة
أ إسماعيل إبراهيم حريري[1]
[1] -أستاذ في الحوزة العلمية
الملخّص :
“قانون الأحوال الشّخصيّة المدنيّة”؛ مشروع لطالما يثير الجدل بعد كلّ طرح له أو تحريك من هذه الجهة أو تلك. وفي الحقيقة، لا يمكن أن يُقرأ خلف هذا المشروع إلا هدف واحد وهو إبعاد النّاس، مجتمعات وأفرادًا، عن الدّين، أي دين. ولكن لا يُخفى، أنّ التركيّز منصبّ في إبعاد المسلمين تحديدًا عن دينهم، بشعارات هذا المشروع الرّنانة والبرّاقة، من حيث الطّرج والشّكل. لكن دومًا، مهما حاولوا تزييف الوقائع، يبقى الدّين وأحكامه النّاصعة مشرقة. في هذه الورقة محاولة سريعة لتبيان أهم المغالطات التي ينسبونها للدّين الإسلامي وتشريعاته.
كلمات مفتاحيّة:
قانون الأحوال الشّخصيّة – المدنيّة- المجتمع المدني- الحضارة الغربيّة- الدّين الإسلامي- أحكام الدّين الإسلاميّة- الشريعة الإسلاميّة – حقوق المرأة في الإسلام.
مقدّمة
إنّ ما سُمّي بـــ”مشروع قانون الأحوال الشّخصيّة[1]” الذي يُراد للناس جميعًا مسلمين وغير مسلمين- وإن كان الحديث عن خصوص المسلمين وأتباع الدّين الإسلامي- أن يطبّقوه في حياتهم المدنيّة والشّخصيّة بديلًا عن أحكام دينهم الذي يدينون به تبعًا لانتمائهم إليه أصولًا وفروعًا، يُفرض على هؤلاء أن يخالفوا أحكام دينهم بأكثر تفاصيله وتشريعاته، فيا تُرى ما هو الدّاعي إلى ذلك؟
يقف في أعلى اللائحة ادّعائهم بطلان أحكام الدّين لعدم ملائمتها والواقع العصري.. وهذا ادّعاء لا دليل عليه. يأتي في المرتبة الثانية، عدم تحقيق العدل الاجتماعي بين أفراد المجتمع بهذه الأحكام؟ وهذا لا دليل عليه، أيضًا. وفي المرتبة الثالثة مسألة أنّ المساواة لا تتحقّق بين الجنسين؟ وهذا محض افتراء.
أمّا ادّعائهم أنّ لا تساوي في الإسلام بين أفراد النّاس، على اختلاف أديانهم، في الإنسانيّة؛ فهذا ينمّ عن جهل بحقيقة التّشريعات الإسلاميّة ومبادئها. إضافة إلى ذلك؛ هناك الشّعارات البرّاقة والدّعاوى الفارغة الواضحة المتّهمة لأحكام الدّين الإسلامي بعد القسط والعدل، والتي نتعاطى معها على أساس أنّها تشريعات إلهيّة، وأحكام نعمل بها لإحراز المعذّريّة عند الله الخالق المبدع والمشرّع العادل الذي لا يمكن في ساحة عدله ورحمته أن يخلق هذا الخلق، ولا يشرّع لهم إلًا ما يضمن لهم سعادتهم في الدّنيا وفوزهم في الآخرة.
وبناءً عليه، نرى عدّة مسوّغات يرفعها أولئك في ادّعاءاتهم مع ردّنا عليها:
- إنّ هذا المشروع كُتب على خلفيّة رفض الدّين وأحكامه، وخصوصًا الدّين الإسلامي؛ لأنّه في أحكامه وتشريعاته مخالفٌ لأغلب موادّ ذلك المشروع.
- أغلب موادّ هذا المشروع، إن لم تكن كلّها، موافقة للقوانين الغربيّة المتّبعة في الغرب في نطاق الأحوال الشّخصيّة.
- اعتمد مقترحو هذا المشروع للترويج له على طرح شعارات العدل والمساواة، ونحوها، لجذب النّاس المنخدعين إليه.
- تسمية أحكام الدّين بقوانين الطوائف إنّما هو تعمية من أصحاب هذا المشروع لإبعاد المسلمين عن دينهم، ولإظهار الأمر وكأنّه صراع أو مواجهة بين قانونين. أحدهما قديم من مئات السّنين، والآخر جديد حديث يناسب متطلّبات العصر والحضارة، وكأنّها حربٌ بين واضِعَين بشرييِّن!!!.
- ليست المسألة فقط زواج مدنيّ؛ بل تتعدّى إلى ما هو أعمق وأخطر من ذلك؛ حيث يُلغي هذا القانون ارتباط المسلم بدينه، ابتداءً من عقد الزواج الذي يُعقد بكيفيّة غير مُقَّرة شرعًا، ولا تنتهي بأحكام الأولاد والزوجة وحقوقهم، والوصيّة والإرث بكلّ تفاصيلها المخالفة عمومًا لأحكام الدّين الإسلامي الحنيف.
- إنّ على المسلمين ألا ينخدعوا بهكذا مشروع، اعتقادًا منهم بصلاحه، وهو في الواقع يبعدهم عن دينهم. وليفهموا أنّ أحكام الدّين الإسلامي هي أحكام مستقاة من أدلّة شرعيّة، عمادها كتاب الله وسنّة نبيّه وخلفاؤه من أهل بيته الطّاهرين، عليهم السّلام أجمعين.
- إنّ انتقاء أحوالٍ شخصيّةٍ تدير لنا أمور حياتنا من زواج وطلاق ووصيّة وإرث وغير ذلك، ليس أمرًا خاضعًا لاختيار الإنسان بعد أن التزم الإسلام دينًا- وتحديدًا المسلم- عقيدةً وشريعةً، فنختار منه ما نرتضيه، ويمكن أن نرتضي ما نشاء من قانون آخر؛ بل علينا أن نلتزم بأحكام ديننا جملةً وتفصيلًا، إلاّ في ما سمح لنا الشّرع الحنيف بالرجوع فيه إلى العرف الاجتماعي المعمول به والمتفق عليه عمومًا، ولا يخالف بجوهره أحكام الشّريعة، أو اللّجوء إلى التراضي إذا كان من الحقوق التي جعل الشّرع الحنيف لأصحابها حقَّ الأخذ بها أو التنازل عنها والتّصالح عليها بما يتراضى عليه مع الآخرين.
إذ إنّ الله تعالى جعل مهرَ الزوجة دينًا في ذمّة زوجها، لكنّ الشّرع الحنيف سمح لها أن تُبرأ ذمّته منه كلًا أو بعضًا. وجعل لها إرثًا منه. كما سمح لها أن تتركه للورثة الآخرين مثلًا. وكذلك الحال في إرث الزوج والأولاد وغيرهم، فلكلّ وارث أن يأخذ ما فرض الله له من حقّ، وله أن يتركه لغيره أو يصالح عليه بما يشاء مع رضى الطرف الآخر في الصلح. كما في مثل حقّ الحضانة لأحد الوالدّين في سنٍّ معيّنة للولد، ذكرًا كان أم أنثى، فلصاحب الحقّ أن يصالح عليه مع الآخر. ومثل نفقة الزوجة التي استقرّت في ذمّة الزوج؛ فإنّها تصير دينًا عليه، فلو أبرأته منها لبرأت ذمّته؛ لأنّ لها ذلك شرعًا. وهكذا … في غيرها من الموارد الكثيرة المشابهة لما تقدّم.
- قد ثبت بالدّليل الشّرعي عند المسلمين جميعًا أنّ المسلمة لا يجوز لها أن تتزوّج بغير المسلم، ولو كان من أهل الكتاب (النّصارى واليهود – والمجوس والصابئة عند بعض الفقهاء)، ومشروع الأحوال الشّخصيّة ذاك يتيح للمسلمة هذا الزواج بحجّة حريّة الإختيار. يدّعون في ذلك أنّ الاختلاف في الدّين لا يمنع من هكذا ارتباط، ولكنّه بذلك هو مخالف لشرع الله تعالى، وتكون المسلمة بهذا الزواج عاصيةً آثمةً إذا أوقعته عن علم وعمد، وهو باطل على كلّ حال، ومع علمها بذلك تكون علاقتها الجنسيّة زنا لعدم الشّبهة من أي منهما؛ والله تعالى يقول: ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا﴾[2]؛ بل مطلق ملامسة مع الطرف الآخر، سواء كان مسلمًا أو غير المُسلم، هي محرّمة.
- ثبت، أيضًا، أساس شروطٍ شرعيّة محدّدة في طلاق الزّوج لزوجه، فلو كان الزّواج شرعيًّا وقام الزّوج المسلم بطلاق زوجه طبقًا لهذا القانون، يكون الطلاق باطلًا إذا لم يكن مستجمعًا لتمام الشّروط الشّرعيّة للطلاق، ومنها الصيغة الخاصّة. ما يعني أنّ المرأة ما تزال على زوجيّة هذا الزّوج، فلا يجوز لها أن تتزوج بآخر، ولو فعلت فشبهة وقعت في الحرام الأكيد.
- لم يثبت أنّ هناك هجرًا بين الزّوجين شرعًا، من دون انفصال بالطلاق، وتاليًا فأيّ انفصال بينهما بمعنى ابتعادهما عن بعضهما البعض في المسكن لا يترتّب عليه آثار الطلاق أبدًا؛ بل لا يجوز هذا الانفصال في بعض الحالات التي تكون فيه مخالفة لأحكام شرعيّة، أو تضييع لحقوق الطرف الآخر من دون رضاه.
- يخالف هذا القانون قاعدة شرعيّة مسلّمة عند المسلمين جميعًا، وهي قاعدة الفراش لقول النبي محمّد صلّى الله عليه وآله: ” الولد للفراش وللعاهر الحجر”. إذ يُلحِقُ هذا القانون ولدًا برجل لا يُنسب إليه شرعًا لتولّده منه بفاحشة الزنا – والعياذ بالله- فيجعله ولدًا له، له ما للولد الشّرعي من حقوق حتّى في الإرث؛ بل حتّى مَن لم يكن من ماء الرجل تكوينًا وتبنّاه صار إبنًا له بالقانون المذكور، له ما للولد من صلبه.
- يجعل هذا القانون للمحكمة المدنيّة المختصّة القول الفصل في إلزام الزوجين بأمور معيّنة، عند النّزاعات ووقوع الطّلاق. كما في إلزام الورثة وأصحاب الحقوق باتّباع طريقة معيّنة في حفظ الحقوق وتقسيم تركة الميّت ونحو ذلك، ممّا هو غير مُلزم له شرعًا إلاّ أن يتراضوا على ذلك، ولا يكون فيه مخالفة لأحكام الدّين الإسلامي.
- لقد ثبت أنّ الجهة الوحيدة المخوّلة بفضّ النّزاعات، في الحقوق الزوجيّة وغيرها، هم أصحاب الحقوق أنفسهم، وإن لم يمكن ذلك فالحاكم الشّرعي أو المحكمة الشّرعيّة الصالحة للبتّ في مثل هذه الأمور. والسبب في ذلك يعود إلى أنّ للحاكم الشرعي دراية بأحكام الدّين التي لا بدّ أن يكون فضّ النّزاعات على أساسها؛ لأنّها دين الله وشريعة الله التي أُمرنا باتّباعها والتزام أحكامها.
- لم يتّضح، ولن يتّضح، ما هو مستند أصحاب هذا المشروع وكاتبيه للموادّ المذكورة في هذا القانون؟.. فهي اعتمدت هي دون سواها. وما هو المرجّح لها على غيرها من موادّ قوانين، أيضًا، موجودة في عالم القوانين الوضعيّة؟ لا نرى مستندًا لها ومرجحًا سوى استحسان هذا القانون دون ذاك، بحسب ما اقتنع به كاتبه برأيه. ومتى كان الرأي الخاص هو الفيصل في بتّ الأمور؟! في حين نرى، بوضوح وإنصاف، أنّ مستند الأحكام الشّرعيّة أساسًا : كتاب الله وسنّة نبيّه وأوصيائه من أهل بيته، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
غير أنّ الفقيه المجتهد يُعمِل جهده وعلمه ودقّته في مراجعة الأدلّة الشرعيّة، وذلك كي يستخرج منها أحكامًا يُقدِّمها لعامّة المكلّفين لتكون لهم سبيلًا يسلكونه في تفاصيل حياتهم ودنياهم. وهم على ثقة بأنّ ربّهم الذين خلقهم يريد منهم الأخذ بهذه الأحكام. ما دام الوصول إلى أحكامه الواقعيّة غير ممكن بعد انقطاع التواصل بهذه الأحكام، لفقد الواسطة وهو النّبي صلّى الله عليه وآله والأئمّة الطاهرين عليهم السّلام.
- يظهر من أصحاب هذا المشروع أنّهم يرَون أحكامَ الدّين قديم قد مرَّ عليها الزمن، ولم تعُد تلائم هذه الأزمنة السّائرة في ركاب الحضارة والتطوّر، ولذلك جاء هذا المشروع مواكبةً لهذا الزمان الذي نحن فيه، وهو ما يتلاءم وعقليّة العدل والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع أفراد الجنس البشري، ولا يكون اختلاف الجنس ولا اختلاف الدّين مانعًا من تحقّق هذه المساواة.
هذا في الواقع جهلٌ بحقيقة ما عليه الأحكام الدّينيّة الإسلاميّة وتحديدًا ما عليه فقه الشّيعة الإماميّة الملتزم بتبعيّة الأحكام الشرعيّة للمصالح والمفاسد المعبّر عنها عند العلماء بملاكات الأحكام ومبادئها، والتي لا يعلمها إلاّ المشرّع الحكيم وهو الله سبحانه وتعالى أولًا. وثانيًا؛ الفقيه لمّا يُفتي فعلى أساس أدلّة شرعيّة معتدّة شرعًا بعيدًا عن أي استحسان واستذواق خاصّين.
نعم؛ يتعاطى الفقهاء مع هذه الأحكام على أنّها أحكام تعبّدية أمرنا الشارع المقدّس باتّباعها تنجيزًا وتعذيرًا علينا ولنا، مع غضّ النظر أنّها تُصيب الأحكام الواقعيّة المجعولة عند الله تعالى أم تُخطئها. وهذا لا يعني أن لا مرونة في هذه الأحكام، فإنّ منها ما يقبل التبديل لكن على أساس ما يُفهم من دليلها الشّرعي وتماشيًا مع لسان هذا الدّليل. ومن هنا كانت مقولة دخالة الزمان والمكان في استنباطات المجتهد وتأثيرها عليها.
خاتمة
الملاحظات المقدّمة، في هذه الدراسة، تهدف الى إلفات نظر المسلمين إلى خطورة ما يطرح من مشاريع أحوال شخصيّة بغيّة إبعادهم عن دينهم عقيدةً وشريعةّ، واستسهال المخالفة لأحكام الدّين الحنيف من خلال تصويرها بصورة قانون الطوائف والمذاهب، ممّا يسقط قدسيّتها ومكانتها في نفوس المسلمين وعقولهم. فمن خلال طروحات معيّنة تمسّ عقيدة المسلم يعملون على إبعاده عن عقيدة الإسلام الحنيف، مثل طروحات “مشروع الأحوال الشّخصيّة”. فجاءت هذه الإطلالة النّقديّة والمقارنة، ولو بنحوٍ من الأنحاء، لبيان مواضع الزلل ونقاط الخلل وما أكثرها في هذا المشروع.
[1] مشروع قانون مقدم من قبل وليد صليبي وأوغاريت يونان إلى أمانة مجلس 2011م.
[2] – سورة الإسراء ، الآية 32.
الإلحاد الجديد: قراءة نقديّة في البنى الإبستمولوجيّة
إنّ تناول مسألة الرّؤى المناهضة للدّين بنسخته الكاملة، الشّاملة للمعتقدات والقيم والتّشريع…